قصة "كارثة المنجم في نيويورك"
هاروكي موراكامي
ترجمة : خالد الجبيلي
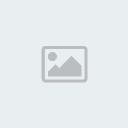
دأب أحد أصدقائي على الذهاب إلى حديقة الحيوانات كلما هبّ إعصار. وهو يفعل ذلك منذ قرابة عشر سنوات. فما أن يغلق معظم الناس خصاص نوافذهم، ويسرعون لتخزين المياه المعدنية، أو تفحّص أجهزة الراديو والمصابيح الكاشفة للتأكد من أنها تعمل، حتى يرتدي صديقي معطفاً من مخلّفات الجيش منذ أيام حرب فيتنام، ويدّس علبتيّ بيرة في جيوبه، وينطلق إلى حديقة الحيوانات التي لا تبعد عن بيته سوى خمسة عشر دقيقة.
وإذا لم يحالفه الحظ، وكانت حديقة الحيوانات قد أغلقت أبوابها "بسبب رداءة الطقس"، فإن صديقي يجلس على درجات تمثال السنجاب الحجري المنتصب إلى جانب مدخل الحديقة، ويحتسي البيرة الفاترة، ثم يقفل عائداً إلى البيت.
أما إذا وصل في الوقت المناسب، فإنه يسدد رسم الدخول، ويشعل سيجارة مبللة بالماء، ويبدأ يتمعن في تلك الحيوانات، الواحد تلو الآخر، التي يلوذ معظمها إلى جحورها وعرائنها. وكانت بعض هذه الحيوانات تقف هناك وهي تحدّق في المطر الهاطل بغزارة، فيما يتقافز بعضها الآخر هنا وهناك في الريح العاصفة. وينتاب بعضها الآخر الخوف من هذا الهبوط المفاجئ في درجة الحرارة والضغط الجوي، فيما يتحول بعضها الآخر إلى حيوانات شريرة.
ويحرص صديقي على أن يحتسي أول علبة بيرة أمام قفص النمر البنغالي. (إذ أن ردة فعل النمور البنغالية هي الأعنف والأشرس دائماً عندما تهب العاصفة)، أما العلبة الثانية فيحتسيها أمام قفص الغوريلا. ففي معظم الأحيان، يكون الغوريلا أقل الحيوانات تأثراً بالإعصار، إذ يقبع هناك وينظر إلى صديقي بعينين هادئتين وهو جالس مثل حورية بحر على الأرض الخرسانية يرشف البيرة، ولا بد أنه كان يشعر بالحزن والأسى عليه.
قال لي صديقي: "يبدو الأمر وكأنك موجود في مصعد تعطّل أثناء صعوده وتجد نفسك فجأة وأنت عالق في داخله مع أشخاص غرباء".
إذا وضعنا الأعاصير جانباً، فإن صديقي لا يختلف عن أي شخص آخر في شيء. وهو يعمل في شركة للتصدير تدير استثمارات أجنبية. وهي ليست من أفضل الشركات، بل شركة متوسطة. ويعيش وحده في شقّة صغيرة نظيفة ويبدّل صديقة كلّ ستّة أشهر. وهو يصرّ على أن يبدّل صديقاته كلّ ستّة أشهر (وهو يفعل ذلك دائماً كلّ ستّة أشهر بالتمام والكمال) ولم أفهم مغزى ذلك. إذ تبدو لي الفتيات جميعهن يشبهن بعضهن، وكأن إحداهن مستنسخة عن الأخرى، إلى درجة أنه يتعذر عليّ أن أميّز الواحدة عن الأخرى.
ويمتلك صديقي سيارة مستعملة جميلة، ومجموعة مؤلفات بلزاك، وبدلة سوداء، وربطة عنق سوداء، وحذاء أسود تلائم تماماً حضور جنازات. فكلما مات شخص، كنت أتصل به وأسأله إن كان بوسعي أن أستعيرها منه، رغم أن الحذاء كان أكبر من قدمي بمقياس واحد.
"آسف لإزعاجك مرة أخرى"، قلت له في آخر مرّة اتصلت فيها معه. "توجد جنازة أخرى".
"تفضل. لا بد أنك مستعجل عليها"، أجاب ثم قال: "لم لا تأتي في الحال؟"
عندما وصلت إلى بيته، كانت البدلة وربطة العنق موضوعة على الطاولة، مكوية بعناية، والحذاء ملّمعاً، وكانت الثلاجة مليئة بالبيرة المستوردة كالمعتاد.
"قبل أيام رأيت قطة في حديقة الحيوانات"، قال، وهو يفتح علبة بيرة.
"قطة؟"
"نعم، منذ أسبوعين. ذهبت إلى هوكايدو في رحلة عمل وذهبت لزيارة حديقة حيوانات بالقرب من الفندق الذي أقيم فيه. كانت توجد قطة تغط في النوم في أحد الأقفاص علقت عليه لافتة كتب عليها "قطة".
"أي نوع من القطط هي؟"
"مجرد قطة عادية. ذات خطوط بنية اللون، ولها ذيل قصير. وسمينة إلى حد لا يصدق. كانت مستلقية على جانبها، وظلت هكذا".
"لعل القطط غير معروفة كثيراً في هوكايدو."
"لا بد أنك تمزح"، قال مندهشاً، "لا بد أنه توجد قطط في هوكايدو. لا يمكن أن تكون قطة غير عادية".
قلت: "حسناً، انظر إلى الأمر بطريقة أخرى: لماذا يجب ألا يكون هناك قطط في حديقة الحيوانات؟" وأضفت: " إن القطط حيوانات أيضاً، أليس كذلك؟"
قال:"إن القطط والكلاب حيوانات عادية. ولن تجد أحداً يدفع نقوداً ليراها"، وأضاف: "إذا نظرت حولك فإنك ستراها في كل مكان. والشيء ذاته ينطبق على الناس".
عندما أنهينا احتساء صندوق البيرة المؤلف من ستة علب، وضعت البدلة وربطة العنق والحذاء في كيس كبير من الورق.
"إني آسف لأني أزعجك باستمرار"، قلت، "فأنا أعرف أنه يجب أن أشتري بدلة لي، لكن ليس لديّ وقت لأفعل ذلك. أشعر بأني إذا اشتريت بدلة لحضور الجنازات فكأني أعرب عن موافقتي إذا ما مات أحدهم".
قال: "لا توجد مشكلة. ففي جميع الأحوال فأنا لا أستعملها. من الأفضل أن يكون هناك شخص يستعملها على أن تظل معلقة في الخزانة طوال الوقت، أليس كذلك؟"
صحيح فهو لم يكد يرتدي البدلة منذ أن اشتراها منذ ثلاث سنوات.
"غريب، فمنذ أن اشتريت البدلة لم يمت ولا شخص واحد أعرفه"، قال موضحاً.
"هكذا هي الحياة".
فردد: "نعم، هكذا هي الحياة".
* *
ومن الناحية الأخرى، كانت هذه السنة سنة الجنازات بالنسبة لي. فقد راح الأصدقاء والأصدقاء السابقون يموتون الواحد تلو الآخر، مثل سنابل القمح التي تذوي وتذبل أثناء الجفاف. فقد كنت في الثامنة والعشرين من العمر. وكان أصدقائي جميعهم في حوالي السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين، وهو ليس العمر الملائم الذي يموت فيه المرء.
قد يموت شاعر وهو في الحادية والعشرين من عمره، أو شاب ثوري أو نجم روك في الرابعة والعشرين. لكنك تظن بعد ذلك أن كلّ شيء سيغدو على ما يرام، وأنك تجاوزت "منعطف الموت" وخرجت من النفق، منطلقاً مباشرة باتجاه المكان الذي تقصده على الطريق السريع ذي الحارات الست سواء – سواء شئت أم لم تشأ. إذ كنت تدأب على الذهاب إلى الحلاق وتقصّ شعرك، وتحلق ذقنك صباح كلّ يوم، أما الآن فلم تعد شاعراً، أو ثورياً أو نجماً من نجوم موسيقى الروك. ولا يعود يغمي عليك من شدة السكر وأنت في كشك الهاتف، أو تقرع الأبواب في الساعة الرابعة صباحاً، أو حتى تشتري بوليصة تأمين على الحياة من الشركة التي يعمل فيها صديقك، وتشرب في حانات الفنادق، وتتمسك بفواتير طبيب الأسنان ليخفضوا لك الضريبة، الذي يعتبر أمراً طبيعياً في سن الثامنة والعشرين.
لكن هذا ما حدث تماماً عندما بدأت المذبحة غير المتوقّعة. كان ذلك أشبه بهجوم مباغت في يوم ربيعي كسول – وكأن شخصاً يقف فوق هضبة وهمية، يحمل رشاشاً وهمياً، ويطلق علينا النار. ففي لحظة نبدّل ثيابنا، وفي لحظة أخرى لا تعود هذه الثياب تلائم مقاسنا: إذ تصبح الأكمام مقلوبة إلى الخارج، وإحدى ساقينا محشورة في فتحة بنطال، والساق الأخرى في فتحة بنطال آخر. فوضى تامة.
لكن هذا هو الموت. فالأرنب أرنب سواء كان يقفز من قبعة ساحر أو في حقل قمح. والفرن الحار هو فرن حار، والدخان الأسود المتصاعد من مدخنة هو ما هو - دخّان أسود يتصاعد من مدخنة.
وكان أول شخص يطأ بقدميه طرفي الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم (أو الوهم والحقيقة) صديقاً من الجامعة يدرّس حالياً اللغة الإنكليزية في المدارس الإعدادية. وكان قد مضى على زواجه ثلاث سنوات، وقد عادت زوجته إلى بيت أبويها في شيكوكو لتلد طفلهما.
وفي مساء يوم أحد دافئ على نحو غير اعتيادي من شهر كانون الثاني، توّجه إلى أحد المخازن الكبيرة واشترى علبتين من معجون الحلاقة وسكيناً كبيرة تكفي لقطع أذن فيل. ثم عاد إلى البيت وفتح صنبور حوض الحمّام. وأخرج من الثلاجة بضع قطع من الثلج، وجرع زجاجة ويسكي كاملة، واستلقى في حوض الحمّام، وقطع شرايين رسغيه. وبعد يومين اكتشفت أمّه الجثة. فجاءت الشرطة والتقطت صوراً كثيرة. وكان الدم قد صبغ الماء في حوض الحمّام وأصبح بلون عصير البندورة (الطماطم). واعتبرت الشرطة أن الحادثة انتحار. إذ كانت جميع الأبواب موصدة، وبالطبع كان المتوفى هو الذي اشترى السكين. لكن لماذا اشترى علبتين من معجون الحلاقة اللتين لم يكن ينوي استعمالها؟ لم يعرف أحد سرّ ذلك.
ربما لم يخطر بباله عندما كان في المخزن الكبير أنه سيكون بعد ساعتين في عداد الأموات. أو ربما خشي أن يعرف أمين الصندوق أنه سيقتل نفسه.
ولم يكتب وصية أو رسالة وداع. ولم يكن يوجد على طاولة المطبخ سوى كأس، وزجاجة الويسكي الفارغة ودلو صغير فيه ثلج، وعلبتي معجون الحلاقة. وفيما كان ينتظر حتى يمتلئ حوض الحمّام بالماء، وهو يجرع كأساً إثر كأس من ويسكي "هيغ" بدون ماء، لا بد أنه حدّق في هاتين العلبتين وفكّر بشيء من قبيل: "لن أحلق ذقني مرة أخرى على الإطلاق".
إن موت رجل في الثامنة والعشرين شيء حزين مثل مطر الشتاء.
خلال الإثني عشر شهراً التالية، مات أربعة أشخاص آخرين.
فقد مات أحدهم في شهر آذار في حادثة في حقل نفط في المملكة العربية السعودية أو في الكويت، ومات اثنان في شهر حزيران إثر نوبة قلبية وحادث مرور. ومن تموز إلى تشرين الثاني ساد نوع من الهدوء، لكن في كانون الأول ماتت صديقة أخرى، في حادث تحطّم سيارة أيضاً.
وبخلاف صديقي الأول الذي انتحر، لم يكن لدى هؤلاء الأصدقاء وقت كاف ليدركوا أنهم سيموتون. فقد كان الأمر بالنسبة لهم مثل صعود درج كانوا قد صعدوه مليون مرّة من قبل وبغتة وجدوا أن درجة قد اقتلعت من مكانها.
"هل سترتبين لي السرير؟" سأل الصديق الذي مات إثر نوبة قلبية زوجته، الذي كان يعمل مصمم أثاث. كانت الساعة الحادية عشر قبل الظهر. كان قد استيقظ في الساعة التاسعة، وعمل قليلاً في غرفته، ثم قال إنه يشعر بالنعاس. توّجه إلى المطبخ، وأعدّ قليلاً من القهوة واحتساها. لكن القهوة لم تسعفه. قال في نفسه: "أظن أني سآخذ قيلولة. إني أسمع صوت طنين خلف رأسي". تلك كانت عبارته الأخيرة. تكوّر في السرير، وغط في النوم، ولم يستيقظ ثانية.
أما الصديقة التي ماتت في كانون الأول فكانت أصغرهم جميعهم، والمرأة الوحيدة بينهم. كانت في الرابعة والعشرين من العمر، وكانت تشبه امرأة ثورية أو نجمة من نجمات الروك. فذات ليلة ماطرة باردة قبل عيد الميلاد، وجدت مستلقية في ذلك المكان المأساوي بين شاحنة وعمود هاتف خرساني.
بعد أيام قليلة من آخر جنازة، توجهت إلى شقّة صديقي لأعيد له البدلة التي أخذتها من محل التنظيف الجاف، ولأقدم له زجاجة الويسكي لأعرب له عن شكري وامتناني.
"لا أعرف كيف أشكرك. إني أقدّر لك ذلك حقاً"، قلت.
كالعادة، كانت ثلاجته مليئة بعلب البيرة الباردة، وكانت أريكته المريحة تعكس شعاعاً فاهياً من نور الشمس. وعلى المنضدة الصغيرة كانت هناك منفضة سجائر نظيفة وأصص نباتات عيد الميلاد.
أخذ البدلة مني، في غطائها البلاستيكي، وكانت حركاته تشبه حركات دبّ خرج لتوه من مرحلة السبات، ووضعها جانباً بهدوء.
قلت: "أرجو ألا تكون رائحة البدلة تشبه رائحة جنازة".
فقال: "إن الثياب ليست هامة. بل المشكلة الحقيقية تكمن في من يرتديها".
"ممممم" همهمت.
"جنازة بعد أخرى بالنسبة لك خلال هذه السنة"، قال، وقد مدّ يده وهو جالس على الأريكة ليصبّ البيرة في الكأس، وسأل: "كم بلغ عدد الجنازات التي حضرتها حتى الآن؟"
"خمس جنازات"، قلت فارداً أصابع يدي اليسرى، وأضفت: "لكني أظن أنها انتهت لهذا العام".
"هل أنت متأكّد من ذلك؟"
"لقد مات عدد كاف من الأصدقاء".
قال: "إنها مثل لعنة الأهرامات أو شيء من هذا القبيل"، وأضاف: "أذكر أني قرأت ذلك في مكان ما. تستمرّ اللعنة حتى يموت عدد كاف من الناس، وإلاّ يظهر نجم أحمر في السماء ويغطي ظلّ القمر الشمس".
بعد أن أجهزنا على ست علب من البيرة، بدأنا نحتسي الويسكي. تسلل ضوء الشمس الشتائي برقة إلى الغرفة.
قال: "تبدو مكتئباً بعض الشيء هذه الأيام".
سألته: "أتظن ذلك؟"
فأجاب: "لا بد أنك تفكّر كثيراً ببعض الأشياء في منتصف الليل. يجب ألا تفكّر بهذه الأمور في الليل".
"وكيف يمكنك أن تفعل ذلك؟"
"عندما يعتريني شعور بالاكتئاب، أشرع في تنظيف البيت، حتى لو كان ذلك في الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً. إذ أغسل الصحون، وأنظّف الموقد، وأكنس الأرض، وأبيّض مناشف تجفيف الصحون، وأنظم دروج منضدتي، وأكوي كلّ قميص تقع عيني عليه"، قال وهو يحرّك كأسه بإصبعه. "إني أفعل ذلك حتى أصبح منهكاً، ثم أتناول مشروباً وأنام. وفي الصباح أستيقظ وما أن أبدأ في ارتداء جوربي حتى لا أعود أتذكر ما كنت أفكّر به".
تلفّت حولي مرة أخرى. وكما هو الحال دائماً، كانت الغرفة نظيفة ومرتبة. "إن الناس يفكّرون بأشياء كثيرة في الساعة الثالثة صباحاً. كلنا نفعل ذلك. لذلك يجب على كلّ واحد منا أن يجد طريقة ليطرد هذه الأشياء من تفكيره".
"أظن أنك على حق"، قلت.
"حتى الحيوانات تفكّر بأشياء في الساعة الثالثة صباحاً"، قال وكأنه يتذكر شيئاً، "هل حدث أن ذهبت إلى حديقة الحيوانات في الساعة الثالثة صباحاً؟"
"لا" أجبت بغموض، "بالطبع لا".
"لقد فعلت ذلك مرّة واحدة فقط. لي صديق يعمل في حديقة الحيوانات، وقد طلبت منه أن يسمح لي بالدخول عندما يعمل في نوبة الليل. ليس من المطلوب أن تفعل ذلك"، هزّ كأسه وأضاف: "كانت تجربة غريبة. لا أستطيع أن أفسرها لك، لكني أحسست وكأن الأرض قد انشقت بسكون تام، وبدأ شيء يخرج منها زاحفاً. بدا أن هناك شيئاً غير مرئي يموج في الظلام. كان وكأن الليل البارد قد تخثّر. لم أتمكن من رؤيته، لكني شعرت به، وأحست به الحيوانات أيضاً. وهذا جعلني أفكّر بأن الأرض التي نمشي عليها تصل إلى باطن الأرض، وأدركت فجأة أن باطن الأرض قد امتص قدراً كبيراً من الزمن".
لم أقل شيئاً.
"على أي حال، لا أريد أن أذهب مرة أخرى إلى حديقة الحيوانات في منتصف الليل".
"هل تفضّل حدوث إعصار؟"
فقال: "نعم، اعطني إعصاراً كلّ يوم".
